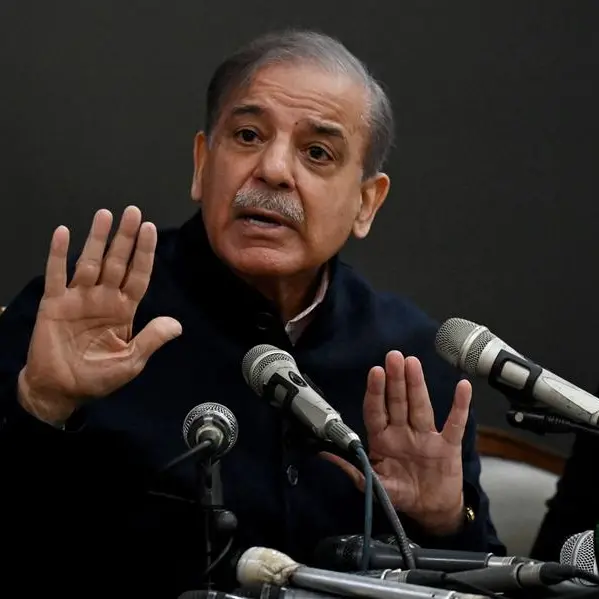PHOTO
لم يكن الفيزيوقراطيون الفرنسيون حين جاءوا في القرن الثامن عشر بنظريتهم الشهيرة laissez faire laissez passer – أي دعه يعمل، دعه يمر – يتوقعون أن تضيف لها العصور الحديثة جزء جديد.
فالنظرية، التي تشير ببساطة إلى معارضة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي إلا على أضيق نطاق، كانت ترى أن التدخل الحكومي يحد من النجاح الاقتصادي وأن السوق الحر والاعتماد على آليات المنافسة جديرة وحدها بتحقيق الرفاهية الاقتصادية، دون تدخل من الدولة التي يجب أن يكون تواجدها الاقتصادي محدود.
وكعادة الجانحين لليبرالية الاقتصادية، فالشأن هنا هو الإيمان بأن القطاع الخاص يملك من الرشادة والحوافز "الصحيحة" ما يجعله جدير بالاستحواذ على المشهد وإدارته، ليصل بالفرد لأقصى مستويات الرفاهية الممكنة.
ولكن، يبدو أن البحث عن الأرباح قد يفقد صوابه أحياناً، متجاوزاً حدود "الرفاهة الاقتصادية للفرد" إلى مساحات تهدد حياته ذاتها. وتتضح هذه الحقيقة البائسة إذا تأملنا العلاقة بين الشركات ومجتمع الأعمال من ناحية، والحروب والنزاعات المسلحة من ناحية أخرى.
الحرب العالمية الأولى
يقول "إيريك لاكوما" الباحث والسياسي السويدي، إن قبل الحرب العالمية الأولى كانت تعبئة الموارد من أجل الحروب في الولايات المتحدة عشوائية إلى حد ما ولا تعتمد على التخطيط المركزي الذي ظهر بقوة مع الحرب العالمية الأولى، بينما الوضع في أوروبا يختلف نوعاً ما، حيث فرضت السلطات في بريطانيا أثناء الحروب النابليونية على سبيل المثال نوع من التمويل للجنود على أصحاب الأبرشيات، وحدات الحكم الكنسي حينها.
ومع الحرب العالمية الأولى، كان لابد آنذاك من شحذ الطاقات المختلفة بما تستدعيه متطلبات الحرب، وهو ما تطلب التعاون بين الكيانات الحكومية والممثلة للدولة كوزارة الدفاع والقوات المسلحة مثلاً، والشركات وأصحاب الأعمال، كمجلس الدفاع الوطني Council of National Defense الذي شكلته الولايات المتحدة في 1916 في خضم الحرب العالمية الأولى، بهدف التنسيق بين الطاقات الإنتاجية للدولة بما يخدم قدراتها الحربية، وقد ضم نخبة من المتخصصين في صناعات مختلفة كالسكك الحديدية والبنية التحتية وصناعة السيارات والمحركات وحتى الطب والجراحة.
وقد كانت تلك الحرب هي بداية لتحالف متسارع بين الذراع السياسي للدولة، الدفاع والقطاع الخاص، الأمر الذي عبر عنه "هوارد إي. كوفن" أحد مؤسسي شركة هدسون لمحركات السيارات، وأحد أعضاء المجلس الذي أشرنا إليه، حين قال إن الحروب في القرن العشرين تحتاج أن يختلط دم الجندي في المعركة بعرق عمال المصانع والمطاحن والمناجم والحقول، في إشارة منه أن الحرب، والبقاء على استعداد للحرب، لم يعد أمر يخص الجبهة وحدها بل ينخرط فيه النشاط الاقتصادي ككل، وهو ما أنشأ روابط قوية بين صناع السياسة والشركات الخاصة التي لها نشاط في التسليح والإنتاج العسكري.
تحذير أيزنهاور
ومع تسابق التسلح المحموم في الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حرب باردة، تعقدت التشابكات في العلاقة بين المسؤولين وصناع القرار في الولايات المتحدة وبين شركات التصنيع العسكري، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في خطاب وداعه للشعب الأمريكي كرئيس لأمريكا في 1961 إلى التحذير من مستقبل يتلاعب فيه ما يسمى Military Industrial Complex بصياغة السياسة الأمريكية بما يضر مصالح الأمريكيين أنفسهم، مشيراً إلى وجوب الحذر حتى لا تضر معايير القوة العسكرية المرغوب فيها والآلة العسكرية الضخمة الباطشة، بالطرق والأهداف السلمية، بحيث يتحقق معاً كل من الأمن، والسلام والحرية كذلك.
ويرمز مصطلح Military Industrial Complex أو المجمع الصناعي العسكري للعلاقات بين صناع السياسة والسلطة العسكرية وبين الصناعة الضخمة التي تغذيها، أو تمدها بالذخائر والعتاد العسكري، الذي لا يقتصر على الصواريخ والطائرات فقط بل يمتد للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات مثل البرمجة والأمن السيبراني.
حيث تنفق وزارة الدفاع على بندين رئيسيين، هما البحث والتطوير والشراء.
ويذهب معظم هذا الإنفاق إلى شركات خاصة (متعاقدين أو متعهدين) في شرائح مختلفة، أولها تلك التي تتعاقد مباشرة مع الكيانات الحكومية مثل لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال داينامكس، ويليها شركات متعاقدة من الباطن ويذهب إليها جزء كبير من تمويل برامج مختلفة للوزارة.
وإن كان التعاون بين الأجهزة الرسمية المعنية بالدفاع وبين القطاع الخاص في الولايات المتحدة ظهر بوضوح في الحرب العالمية الأولى كما أشرنا، إلا أن المجمع الصناعي العسكري قد أخذ شكله الحالي الذي نعرفه في الخمسينات من القرن الماضي.
واختارت الولايات المتحدة فلسفة في دفاعها تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، سواء في المجال النووي أو التقليدي. وهو ما يعني تزايد الإنفاق على البحث والتطوير، وهو ما لم يكن من الممكن لكيان حكومي مواكبته.
وبالتالي بدلاً من الإنفاق على البحث والتطوير داخلياً تم تمويل الصناعة المختصة، كتمويل برامج صناعات الطيران واختباراتها وشراء المخرجات النهائية ذات النتائج الناجحة.
دعه يعمل .. دعه يفعل ما يشاء
يشكل نمط المجمع الصناعي العسكري مادة خصبة للبحث والمراقبة، حيث يمثل علاقات مصالح جديرة بالدراسة تتجاوز فكرة التعاقد والتوريد.
فطالما دخل البحث عن الربح والمصالح المادية في دوائر قريبة لصناعة القرار. ولم يعد من السهل أن تثق في طبيعة الدوافع وراء القرارات المختلفة ولا في مدى نزاهته أو مشروعيته أو جدية مبرراته.
فالإنفاق العسكري الضخم الذي تتسم به الولايات المتحدة حقيقة جلية، يجعل بند الدفاع يبتلع 12.9% من إجمالي الإنفاق في 2022 و13.9% في 2023 متجاوزاً الإنفاق على الصحة 11% (ولا نتحدث هنا عن برنامج medicare للتأمين الصحي) وكذلك الإنفاق على التعليم بفارق كبير (3.2%).
وقد مثل الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بحسب البنك الدولي.
وربما تتضح ضخامة النسبة إذا ما أشرنا إلى أن تلك النسبة في الصين تبلغ 1.6% وفي ألمانيا 1.4% وفي المملكة المتحدة 2.2%. ومع ضخامة حجم الاقتصاد الأمريكي، تكون تلك النسبة المرتفعة رقم وقدره.
وهو مشهد لا يجعلك إلا أن تتساءل: هل هذا الغدق بدعوى احتياجات عسكرية حقيقية، وتأمين مبرَر لمصالح الدولة خارج حدودها، أو حتى لمجرد امتلاك أسلحة رادعة، أم، وبأية نسبة، هو بدعوى ضغوط الشركات المنتفعة من زيادة الضغط نحو الإنفاق العسكري إلى حد افتعال الأخطار الخارجية لتحتفظ بسخاء التعاقدات الحكومية.
ولما تقوم تلك الشركات بالتبرع للسياسيين أثناء الحملات الانتخابية؟ وهل يمكن أن يقدم المتبرعون أرقام طائلة لهذا السياسي أو ذاك، بدون أن تتدخل بما يضمن بقاء وزيادة مصالحها الاقتصادية؟
فبحسب مؤسسة Open Secrets غير الهادفة للربح والمعنية بمراقبة الأموال المنفقة لدعم السياسيين وتكوين فرق الضغط Lobbies، أنفق قطاع الدفاع 365 مليون دولار منذ 1990 حتى 2021 لدعم المرشحين السياسيين، كما أنفق في عام 2021 وحده 117 مليون دولار للتواجد الممثل بجماعات الضغط التي تمثل مصالح القطاع.
ولا يمكن أن تكون مصالح القطاع تلك بعيدة عن ضمان استمرار تدفق التعاقدات الحكومية الضخمة لصالح تلك الشركات، وهو ما يستدعي وجود "ضرورة" تبرر لدافع الضرائب الأمريكي هذا الكرم في تمويله، وهو ما يفسر كون الولايات المتحدة دولة نشطة عسكرياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولكي نفهم ماذا تعني الحروب والنزاعات لتلك الشركات، نشير أن سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفع من 398 دولار للسهم في 5 أكتوبر، إلى 435 دولار للسهم في 9 أكتوبر الماضي، أي بنسبة 9%، وارتفع سهم جنرال داينامكس بنسبة مشابهة من 218 دولار إلى 238 دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يبدو أنه رد فعل مباشر لاندلاع الحرب في غزة خلال تلك الفترة.
وكل ما سبق يدفع للتأمل حول هذا الوحش الذي حذر منه أيزنهاور على استحياء في خطابه الشهير، والذي يعيش وينمو في دولة طالما نادت بالديمقراطية وفصل أيديولوجيات بعينها عن السياسة وصنع القرار.
(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر)
(للتواصل zawya.arabic@lseg.com)