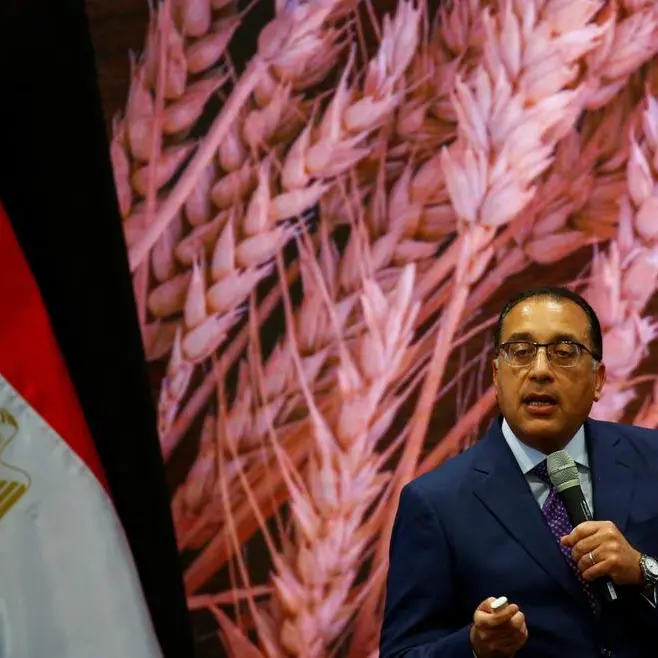PHOTO
لم يقض المصريون عيد الأم هذا العام في اختيار الهدايا المناسبة لأمهاتهم، ولم يكن النقاش الدائر داخل البيوت المصرية هو اختيار طقم أكواب هنا أو قطعة من الحلي هناك.
وإنما استيقظوا يوم الحادي والعشرين من مارس على قرارات اقتصادية اتخذها البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، وهي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة صاحبها انخفاض لقيمة الجنيه المصري في البنوك الحكومية بحوالي 10% ليصل إلى 17.45 جنيه للدولار الواحد، وبالطبع لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث استمر الدولار في الارتفاع ليصل إلى 18.5 جنيه. ولا تعنينا هنا الأرقام في ذاتها فأخبار الاقتصاد تحتوي الكثير منها، ولكننا سنحاول أن نفهم الأحداث بأبعادها، طولاً وعرضاً وارتفاعاً.
إجراءات قاسية لمتغيرات عالمية أكثر قسوة
فمبدئياً، يجب أن نوضح أن قرارات البنك المركزي هي علاج قاسي نوعاً اضطررنا لتجرعه في ظل أزمة عالمية، في سبيل محاولة تفادي تحولها لأزمة محلية مكتملة الأركان، لتفادي شبح شح العملة الأجنبية بشكل يهدد الاقتصاد المصري.
فما حدث ببساطة أن الاقتصاد قد تأثر على مدار سنتين بأزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على التعاملات الخارجية لمصر، حيث تدهور بشدة أداء قطاع السياحة جراء الجائحة مسجلاً فقط 4.9 مليار دولار في العام المالي 21/2020 بعد أن قارب مستوى الـ 13 مليار دولار في عام 19/2018.
ودعني أذكرك عزيزي القارئ أن السياحة هي أهم مكون في ميزان الخدمات المصري، وهو الميزان الذي تحقق فيه الدولة فائض على مدار تاريخ بياناتها المتاحة، ويساعدها – كأحد بنود الحساب الجاري الشق الهيكلي لميزان المدفوعات - على تلبية بعض احتياجات العجز التجاري السلعي المزمن والنهم بشدة للدولارات، مما يخفف من وطأة عجز الحساب الجاري ككل، بالطبع مع الامتنان لتحويلات العاملين بالخارج التي تلعب دور ربما يفوق أهمية السياحة في بعض الأحيان.
ولم يكد الاقتصاديون في مصر يحتفون ببدء تعافي السياحة وعودة القطاع إلى صحته حتى اندلعت الحرب في أوكرانيا، مؤثرةً على جوانب عدة ليس انخفاض وتيرة وفود السياح هو آخرها بل أدى ارتفاع أسعار السلع والحبوب والذي كان حتى متزايد بالفعل قبل اندلاع الحرب، إلى تحديات جسيمة للسياسة المالية وإدارة الموازنة العامة، حيث تستورد مصر العديد من السلع التموينية من أهمها ولكنه ليس الوحيد هو "القمح" وكذلك السلع البترولية، وكلاهما يتطلب عملة أجنبية بدوره كذلك، في ظل تأثر السياحة وبعد عامين من ارتفاع عجز الحساب الجاري والذي أثر بشدة على الأصول الأجنبية للبنوك.
تشوهات سعرية
ولذا، قرر المركزي تحريك قيمة العملة المحلية بما يعبر عن تراكم قوى العرض والطلب، ليس لصالح الجنيه المصري بالطبع.
وقد أدرك المركزي ما تعلمناه في سنوات سابقة: أن استمرار تثبيت سعر العملة على مستوى غير حقيقي وغير مستدام على أمل تحسن الظروف في القريب العاجل لا يزيد الأمور على الأرجح إلا تعقيداً، حيث لم يزل درس 2015 و2016 حاضراً في الرؤوس، حين وصل الاقتصاد لمرحلة من الجمود بسبب أزمة العملة وانعدام الثقة في استمرار السعر الرسمي الذي تمسك به المركزي وقتها للعملة المحلية أمام الدولار. ولذا، اعتبر المركزي والمجتمع الاقتصادي عموماً إجراءات مارس الحالي نوعاً من التصحيح لقيمة الجنيه لتفادي أزمة عملة تؤدي لتآكل الاحتياطيات الرسمية وتفاقم أزمة ثقة تجاه الاقتصاد المصري بالذات لو تكلمنا عن العالم الخارجي، من المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية.
فبُعد القيمة الإسمية للعملة عن قيمتها الحقيقية يعتبر أحد التشوهات السعرية التي تسبب تشتيت في الحوافز الاقتصادية لدى المتعاملين في سوق ما.
فعلى سبيل المثال، إن كانت العملة المحلية لدولة ما مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، أو بمعنى آخر تعاني ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي الفعال الخاص بها، يؤدي ذلك لارتفاع الواردات وانخفاض تنافسية الصادرات بما لا يتسق مع هيكل الاقتصاد الخاص بها وكفاءته.
ليست المرة الأولى
لطالما كان تسعير العملة في مصر محل نقاشات ودراسات، ولم يكن هناك حديث عن برنامج إصلاح اقتصادي لم يكن سعر الصرف حاضراً فيه وبقوة. فمنذ مطلع التسعينات وحتى يومنا هذا، احتاجت السلطات النقدية المصرية إلى أربع "صدمات" لها علاقة بتحريك كبير وغير تدريجي في سعر الصرف، إذا استثنينا تحركات تدريجية أو متخبطة في بعض السنوات. ولكن المحطات الأربع الرئيسية هي:
(1) تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي Economic Reform and Structural Adjustment Program (ERSAP) والذي تضمن رفع أسعار المحروقات وإعادة تسعير الجنيه أمام الدولار بجانب تبني أكبر لآليات السوق (ألا يبدو هذا الكلام مألوفاً؟)
(2) المرة الثانية في 2003 وهي في اعتقادي بداية معرفة العامة بمصطلح "تعويم" والذي لا يعني لرجل الشارع إلا موجة غلاء على الأغلب، حيث أعلن رئيس الوزراء آنذاك في أواخر يناير 2003 تعويم الجنيه المصري، لتتماشى مع حزمة من السياسات تهدف لتشجيع القطاع الخاص ومحاصرة السوق السوداء والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية وبناء نظام مصرفي قوي بعد أزمة أواخر التسعينات والتي عرفت بأزمة نقص السيولة.
(3) والمرة الثالثة وهي الأشهر لدى جيلنا والأكثر عنفاً ربما، هي التي قام بها المركزي ليلة 3 نوفمبر 2016 بالسماح للجنيه أن يعكس قوى العرض والطلب، إلا أن الجنيه تجاوز الحد وانخفض أكثر مما يستدعيه الأمر فيما يعرف بالـ overshooting، فاقداً أكثر من نصف قيمته وظل فترة طويلة مقوماً بأقل من قيمته الفعلية وفق بعض النماذج الاقتصادية، دفع خلالها المصريون ثمن غالي من التضخم الذي وصل إلى 35% على أساس سنوي في بعض أشهر عام 2017، لاسيما أن خفض العملة وقتها صاحبه باقي إجراءات الحزمة المعروفة التي يشترطها صندوق النقد: رفع دعم المحروقات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
(4) المرة الرابعة هي التي دفعتنا لكتابة هذا المقال، حيث انخفض الجنيه مقابل الدولار صبيحة يوم 21 مارس، هو أمر كما أشرنا يعود إلى معطيات عالمية وأزمة طالت العالم والأسواق الناشئة بشكل خاص.
ويبقى السؤال.. لماذا العلاج متكرر والمشكلة مازالت قائمة؟
رغم اعترافنا بالعامل الخارجي الذي أدى للتحريك الأخير لسعر العملة، إلا أن العامل الأساسي والأكثر تأصلاً وخطورة في تكوين الاقتصاد المصري ليس عالمياً على الإطلاق، بل ولا يتعلق في معظمه بالسياسة النقدية أصلا.
فالبنك المركزي ليس دوره تعبئة الموارد الدولارية للدولة، وإنما هو معني أكثر بإدارتها. أما توافر الموارد الدولارية من عدمه هو نتاج تفاعل الاقتصاد نفسه، بإطاره التشريعي وتنافسيته، بإنتاجية أفراده وشركاته وميزتهم التنافسية والقيمة المضافة التي يصدرونها للعالم.
ورغم تصدر البنك المركزي المشهد فيما يخص سعر العملة والإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه في رأيي لا يتحكم بشكل أساسي في الاقتصاد وهيكله، وإنما هو يستجيب لمعطيات يجدها أمر واقع - عليه أن يديرها - وهي نتاج كفاءة الاقتصاد ذاته، محاولاً أن يجد المعادلة النقدية المثلى لتجنب الأزمات وتحفيز البيئة الاقتصادية قدر الإمكان.
فمن أهم المشاكل الهيكلية التي تبتلع الدولار ابتلاعاً، هي عجز مزمن في الميزان السلعي، حيث استوردت مصر على سبيل المثال سلع بحوالي 70 مليار دولار في العام المالي 21/2020، في مقابل حوالي 29 مليار دولار فقط من الصادرات السلعية خلال نفس العام.
والفكرة هنا ليست الأرقام فحسب، بل يكمن السر في القيمة المضافة. فبالنظر لهيكل الواردات، نجد أن حوالي 73% منها هي سلع وسيطة واستثمارية أو حتى استهلاكية لها مكون تقني من نوع ما، كالسيارات والأجهزة الكهربائية، وهي أنواع من السلع تمتاز بقيمة مضافة أعلى نسبياً، بالمقارنة بالمواد الخام التي تشكل 23% فقط من إجمالي الواردات، بينما تفتقر الصادرات المصرية لمكون غني في قيمته المضافة حيث تحتل صادرات المواد الخام حوالي 42% من إجمالي الصادرات، وهي نسبة مهولة.
وينطوي ذلك أيضاً على مشكلة أخرى وهي "كثافة المكون المستورد للصادرات" Imports intensity of exports، أي أن الصادرات يلزمها بالأساس مكون مستورد كثيف كالسلع الاستثمارية اللازمة لخطوط الإنتاج وغيره، مما يجعل استفادة الصادرات المصرية من انخفاض قيمة العملة محدود للغاية، حيث يأكل ارتفاع أسعار المكون المستورد من تنافسية سعر السلعة النهائية وقت التصدير، مشكلاً تحدي كبير للتوسع بالخارج، وقد ظهر ذلك بوضوح في عدم استفادة العجز التجاري المصري من انخفاض سعر الصرف الكبير في 2016.
ولذلك، يمكننا أن نقول أن أية حلول تبعد عن تحسين الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة بما يتطلبه ذلك من إصلاحات شاملة أولها البيئة الاستثمارية وليس آخرها تطوير التعليم الفني، هي حلول تعتبر مسكنات مؤقتة لمرض مزمن، وتبقى مجرد إعادة تسعير لنفس الاختلالات بذاتها.
فبدون إعطاء أولوية واضحة لخطة تصنيع متوطنة واضحة قائمة على رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وتنويع صادرات أكبر، وذلك بالطبع في إطار أكثر شمولاً لمراجعة أولويات الإنفاق العام وتعديلات تشريعية مشجعة لبيئة أفضل للاستثمار، بدون كل ذلك، ومادامت نفس الهشاشة تجاه المتغيرات العالمية بنفس العنف، يمكننا القول أن إجراءات مارس لن تكون الأخيرة من نوعها، وسيظل المصريون عرضة لإجراءات قاسية من حين لآخر لتفادي أزمات أكبر، تلك الإجراءات التي تشبه في قسوتها إجراء جراحة بدون مخدر.
(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بمصر والمحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كمحللة اقتصادية أولى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحثة اقتصادية في عدة وزارات مصرية)
(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
#مقالرأي